أزمة الهوية: حلقة مفرغة بين العقل والواقع
 |
اجتماعياً: تصدّع الأسرة، تراجع الروابط المجتمعية، تهميش الطبقات الشعبية، وانهيار النموذج التربوي.
ثقافياً: هيمنة ثقافة أجنبية، تهميش اللغة الوطنية، زرع قيم التبعية، وتقزيم الإنجازات الحضارية المحلية.
في هذا السياق، لا يمكن للفكر أن ينمو في بيئة سليمة، فيُولد العقل مُقسّماً: يُفكر بلغة أجنبية، لكنه يُصلي بلغة قديمة؛ يُحبّ بلاده، لكنه يُحرج من لهجته؛ يُدرّس التاريخ، لكنه لا يُؤمن به.
هكذا، تُولد أزمة الهوية من تناقض مادي بين المرجعيات، لا من خلل نفسي فردي.
يُهاجر روحياً قبل أن يهاجر جسدياً: يُحبّ الغرب قبل أن يزوره.
تُصبح الهوية مادة للتمييز: "أنت ليس عربياً حقاً"، "أنت غربي الميول"، "أنت لا تحترم التقاليد".
يُهيمن الإعلام الدخيل، وتُهمش الفنون الأصيلة.
هكذا، تُعيد أزمة الهوية صياغة الواقع الذي أنتجها، لكن بنسق أكثر تشوهاً.
مثال: جيل تعلّم بلغة أجنبية في المدرسة جيل يُربّي أبناءه بلغة أجنبية في البيت جيل ثالث لا يفهم لغة أجداده.
تراكم كيفي: تتطور الأزمة من "حيرة" إلى "رفض"، ثم إلى "عداء تجاه الذات"، وصولاً إلى "الانتحار الحضاري" (تقليد أعمى، تدمير التراث، هجرة جماعية للعقول).
وهكذا، تصبح الأزمة أعمق، أكثر تعقيداً، وأصعب علاجاً.
إحياء اللغة: جعل اللغة الوطنية لغة تفكير، وتعليم، وإبداع، لا مجرد رمز شكلي.
بناء دولة وطنية جامعة: تُحقق العدالة، وتُعطي كل مواطن شعوراً بالانتماء المتساوي.
دعم الإنتاج الثقافي المحلي: الفن، السينما، الأدب، الموسيقى، كلها أدوات لاستعادة الهوية.
إعادة قراءة التاريخ بوعي نقدي: ليس تقديساً، ولا تجريحاً، بل فهماً ناضجاً للماضي، ليكون دليلاً للحاضر.
ليست مجرد "حيرة فكرية"، بل مأساة حضارية تُهدّد بقاء الشعوب ككيانات مستقلة.
وهي ليست خطراً مستقبلياً، بل واقعٌ معيّش، يُترجم في كل تفاصيل الحياة: كيف نُربّي، كيف نُعلّم، كيف نُنتخب، كيف نُحبّ، كيف نُدافع.
لكن في المقابل، إذا تمّ التدخل بوعي، وإرادة، واستراتيجية، يمكن تحويل هذه الحلقة إلى حلقة إيجابية:
وعي بالهوية → إصلاح في التعليم → تقوية الثقافة → بناء دولة قوية → ترسيخ الانتماء → تجديد الهوية.
لأن الشعوب لا تنهار بالفقر وحده، بل تنهار عندما تنسى من تكون.
وإنقاذ الهوية، إذاً، ليس رفاهية فكرية، بل شرط بقاء.
إيغوصار



 كتابة الامازيغية
كتابة الامازيغية
 الحركة الثقافية الامازيغية
الحركة الثقافية الامازيغية
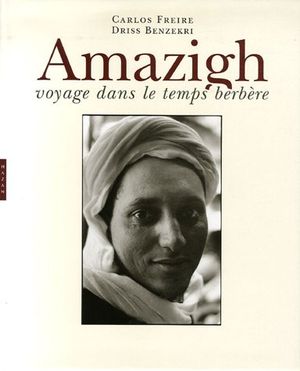 رحلة في الزمن الامازيغي
رحلة في الزمن الامازيغي
 الامازيغ هوية وذاكرة
الامازيغ هوية وذاكرة
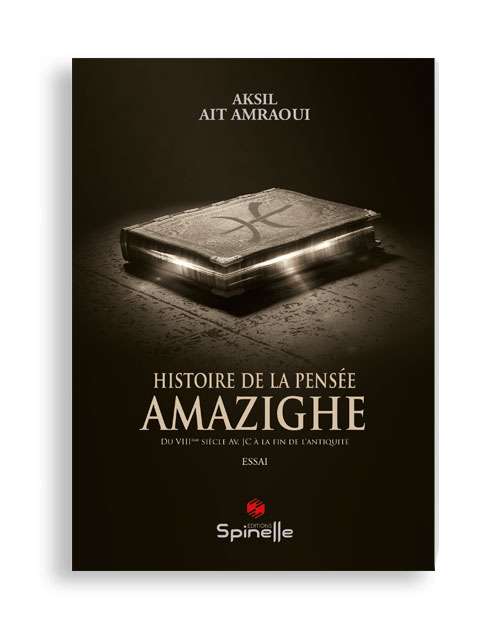 تاريخ الفكر الامازيغي
تاريخ الفكر الامازيغي








ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق