عنف أزمة الهوية: بين التمزق الداخلي والانفجار الخارجي
في عالمٍ تتداخل فيه الثقافات وتتسارع وتيرته، وتُعاد فيه تعريفات الهوية كل يوم، باتت أزمة الهوية ليست مجرد سؤال فلسفي وجودي، بل حالة مزمنة تُصيب الفرد والمجتمعات، تولد عنفًا خفيًا وظاهرًا، داخليًا وخارجيًا. هذا العنف لا يُقاس بالدم أو الدمار المادي وحده، بل بأعماق التمزق النفسي، وبشدة الانفجارات السلوكية التي تأتي كرد فعل لفراغ داخلي عميق.
أزمات الهوية لا تصيب من فقد انتماءه فحسب، بل تطال من يعيش بين انتماءات متعددة، أو من يشعر بتناقض بين ما هو عليه وما ينبغي أن يكون. في هذا الفراغ، يولد عنف مضاعف: عنف داخلي يحطم الذات، وعنف خارجي يُوجّه إلى الآخر.
العنف الداخلي: تدمير الذات من الداخل
أول ضحايا أزمة الهوية هو صاحبها. فعندما يفقد الإنسان إحساسه بالثبات، عندما يشعر أنه لا ينتمي تمامًا إلى ثقافته الأصلية، ولا يستطيع الاندماج الكامل في الثقافة الجديدة، أو عندما يُنظر إليه كـ"غريب" في وطنه، أو "مريب" في مغتربه، يبدأ التفكك من الداخل.
هذا التفكك ليس مجرد شعور بالحزن أو الحيرة، بل هو عنف نفسي وفكري. إنه صراع مستمر بين صوتين: صوت الأصل وصوت الحداثة، صوت الدين وصوت العقل، صوت الأسرة وصوت الفرد. وكل محاولة للتوافق تُقابل بخيبة أمل، لأن الحلول لا تُبنى على قناعة، بل على تسوية مؤقتة. هنا، يتحول الإنسان إلى ساحة حرب، يُهاجم فيها من الداخل، ويُستهدف فيه الشعور بالذات، بالمعنى، بالقيمة.
هذا العنف الداخلي يتجلى في أشكال متعددة: القلق المزمن، الوسواس الفكري، الهوية المُتلونة حسب الموقف، أو حتى الانتحار الروحي – حيث يعيش الإنسان دون إحساس بالمعنى، كظل يمشي بين الناس.
العنف الخارجي: صرخة منسية تتحول إلى عدوان
لكن ما لا يُقال غالبًا هو أن هذا العنف الداخلي لا يبقى مُحبوسًا. فمثلما لا يمكن لوعاء مملوء بالضغط أن يصمد، فإن النفس المُتَازِمة تبحث عن منفذ. وهنا يولد العنف الخارجي، ليس بالضرورة كاعتداء جسدي، بل كتعبير مرضي عن حالة التمزق.
قد يظهر هذا العنف في شكل:
تمسك متطرف بهوية معينة، كأن يقول المُتَازِم: "أنا مسلم 100%" أو "أنا عروبي حتى النخاع"، ليس انتماءً حقيقيًا، بل كرد فعل نفسي ضد الشعور بالضياع.
رفض الآخر المختلف، ليس بسبب فكره، بل لأنه يُذكّره بذاته المُتعددة، فيُصبح الآخر تهديدًا وجوديًا.
الانخراط في خطاب كاره أو متطرف، سواء على الإنترنت أو في الواقع، كوسيلة لتأكيد الوجود: "إذا لم أعرف من أنا، فسأعرف من أكره".
في هذه الحالة، لا يكون العنف الخارجي تعبيرًا عن قوة، بل عن ضعف مكتوم. إنه صرخة مكبوتة تُحوّل إلى عدوان، لأن المجتمع لا يُفسح المجال للتساؤل، ولا يُحتمل الشك، ولا يُقدّر الألم الوجودي.
المتازمون: ضحايا أم جناة؟
السؤال الأصعب: هل المُتَازِمون جناة عندما يُمارسون العنف؟ أم هم أنفسهم ضحايا؟
الجواب: هم كلاهما. فهم ضحايا لواقع اجتماعي يُقصي المُختلف، ولتعليم لا يُعلّم التفكير النقدي، ولأسرة قد تُكرّس انتماءات ضيقة، ولعالم رقمي يُضخم الكراهية. لكنهم في الوقت نفسه، حين يُفجّرون هذا العنف، يُصبحون جناة على الآخرين، على المجتمع، وعلى أنفسهم.
وهنا تكمن المأساة: أن يُحوّل الإنسان نفسه من ضحية إلى جاني، ليس بدافع الشر، بل بدافع البقاء الوجودي.
طريق الخروج: الهوية كمساحة حوار، لا كحصن مغلق
الحل لا يكمن في فرض هوية واحدة، ولا في نبذ الهويات المتعددة، بل في تحويل الهوية من حصن مغلق إلى فضاء مفتوح للحوار. أن نُعلّم الإنسان أنه يمكن أن يكون متعددًا، مركبًا، متحركًا، دون أن يعني ذلك فقدانه لذاته.
الهوية ليست شيئًا يُورث أو يُفرض، بل شيئًا يُبنى، ويُراجع، ويُعاد تشكيله. والسلام مع الذات لا يأتي من التمسك الأعمى، بل من الشجاعة في طرح السؤال: "من أنا؟"، دون خوف من الإجابة.
الخلاصة:
عنف أزمة الهوية هو دورة مغلقة من التدمير الذاتي والعدوان على الآخر. وهو لا يُعالج بالقمع أو بالخطابات التحريضية، بل بالاستماع، بالتفهّم، وبإعادة بناء ثقافة تُحترم فيها الشكوك كما تُحترم اليقينات. لأن الإنسان الذي يعرف تمزقه، ويعترف به، هو أول من يمكنه أن يعبر إلى عالم أكثر إنسانية
إيغوصار




 كتابة الامازيغية
كتابة الامازيغية
 الحركة الثقافية الامازيغية
الحركة الثقافية الامازيغية
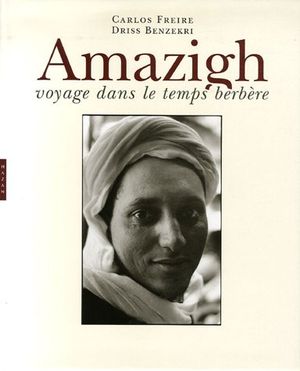 رحلة في الزمن الامازيغي
رحلة في الزمن الامازيغي
 الامازيغ هوية وذاكرة
الامازيغ هوية وذاكرة
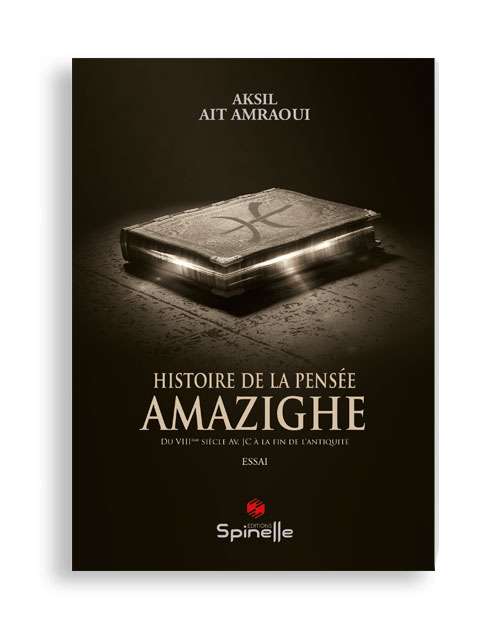 تاريخ الفكر الامازيغي
تاريخ الفكر الامازيغي








ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق