تُعدّ قضية الهوية في شمال إفريقيا المغربية، الجزائرية، التونسية، الليبية، الموريتانية مصر من أبرز القضايا الفكرية والسياسية التي ما فتئت تتفاعل مع التحولات العميقة في المجتمعات، وتتصدر واجهة النقاشات العامة، خصوصًا في فترات التحوّل أو الأزمات. لكن ما يلفت النظر هو أن
الهوية الشمال إفريقية أقدم بكثير من الأيديولوجيات الحديثة التي برزت في القرن العشرين، كالقومية العربية، أو الاشتراكية، أو الإسلام السياسي، أو الليبرالية.
فالهوية هنا ليست نتاجًا حديثًا، بل هي تراكم حضاري، لغوي، ثقافي، اجتماعي، وروحي، يمتدّ إلى آلاف السنين. إنها هوية مركبة، متعددة الطبقات: أمازيغية في جذورها العميقة، متأثرة بالحضارات الفينيقية، والرومانية، والبيزنطية، والإسلامية، والعثمانية، والاستعمارية، لكنها لم تفقد يومًا خصوصيتها. هوية سابقة لأي أيديولوجيا، ومستقلة عنها من حيث الأصل، وإن تأثرت بها لاحقًا.
الهوية سابقة، والأيديولوجيا لاحقة
من المهم التأكيد أن الهوية لا تُبنى بالأيديولوجيا، بل تُختَزلُ فيها أحيانًا. فالهوية تتشكل عبر الزمن، من خلال اللغة، والتقاليد، والمكان، والذاكرة الجماعية، والارتباط بالأرض. أما الأيديولوجيا، فهي بناء فكري وسياسي حديث، يهدف إلى تفسير الواقع، وتنظيم المجتمع، وتحقيق التغيير.
لكن في شمال إفريقيا، تداخلت الأيديولوجيات في الخطاب الهوياتي، ليس لخدمة الهوية، بل لاستخدامها كأداة مشروعيّة. فقد لجأت الأنظمة، والقوى السياسية، والحركات الفكرية، إلى "هوية" ما — عربية، إسلامية، أو قومية — لتكريس شرعيتها، وتحقيق هيمنتها، بينما كانت في الحقيقة تُعيد تعريف الهوية وفق أجندات أيديولوجية، لا وفق واقع مركب ومعقد.
الصراع الأيديولوجي يُلبس ثوب الهوية
ما نشهده اليوم في بعض البلدان الشمال إفريقية ليس صراعًا هوياتيًا حقيقيًا، بل هو صراع أيديولوجي يُخفي وجهه وراء مسألة الهوية. فالصراع بين "العربي" و"الأمازيغي"، أو بين "الإسلامي" و"العلماني"، أو بين "التقليدي" و"الحداثي"، غالبًا ما يكون في جوهره صراعًا على السلطة، وعلى مشروع مجتمعي، وليس على الهوية بحد ذاتها.
لكن هذا الصراع يُحوّل إلى "أزمة هوية" ظاهريًا، لأن الهوية تُستخدم كأرضية رمزية أقوى للتعبئة الجماهيرية. فالادعاء بأن "اللغة العربية" أو "الهوية الإسلامية" مهددة، أو أن "الهوية الأمازيغية" مستبعدة، هو في كثير من الأحيان أداة سياسية لتعبئة القواعد، وتحقيق التفوق في الصراع على النفوذ.
هكذا، يُنقل الصراع من حقل السياسة والاقتصاد إلى حقل الهوية، فيُصبح الهوية مذنبًا، بينما المذنب الحقيقي هو التخلف الأيديولوجي، وضعف المشروع الوطني، وغياب رؤية شاملة للدولة الحديثة.
محاولة بائسة: تغطية تأخر الوعي بالهوية
إن تحويل الهوية إلى محور الصراع، وتصويرها على أنها "جوهر المشكلة"، هو محاولة بائسة لتغطية تخلف الوعي السياسي والفكري. فبدل أن نناقش بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير التعليم، وتعزيز الديمقراطية، نُغرق في جدالات حول "من نحن؟" بطريقة تقسيمية، تُحوّل الهوية إلى ساحة حرب، بدل أن تكون جسرًا للوحدة.
وهذا التأخّر في الوعي يُعيق بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة، والحقوق، والقانون، بدل أن تقوم على الانتماءات الفرعية (لغوية، دينية، إثنية). فالهوية، حين تُستخدم كوسيلة للتمييز، لا تُوحّد، بل تُفرّق. وحين تُختزل في بُعد واحد (كالانتماء الديني أو اللغوي)، تُفقد تنوعها وغناها.
الهوية ليست عائقًا، بل موردًا للبناء
الهوية الحقيقية، في شمال إفريقيا، ليست عبئًا على الحداثة، بل موردًا ثريًا لبناء دولة ديمقراطية ومتعددة. فالتنوع اللغوي (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، والإنجليزية)، والانتماءات الثقافية المتعددة، والانفتاح التاريخي على المتوسط والصحراء، كلها عناصر يمكن أن تُبنى عليها هوية وطنية جامعة، تقوم على التعدد، لا الوحدة القسرية.
لكن ذلك يتطلب شجاعة فكرية: الاعتراف بأن الهوية ليست ملكًا لتيار أيديولوجي واحد، ولا يمكن اختزالها في شعار أو خطاب. بل هي فضاء مشترك، ينتمي إليه الجميع، بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الديني.
الهوية كجسر، لا كجدار
لبناء ديمقراطية حقيقية في شمال إفريقيا، لا بد من فكّ الارتباط القسري بين الهوية والأيديولوجيا. يجب أن تُعاد الهوية إلى موقعها الطبيعي: كذاكرة جماعية، وكنسيج اجتماعي، وكنقطة انطلاق للوحدة، لا كأداة تمييز أو هيمنة.
الدولة الحديثة لا تُبنى على إنكار الهوية، ولا على توظيفها سياسياً، بل على الاعتراف بها في تنوعها، وتحويل هذا التنوع إلى قوة اندماجية، لا إلى مصدر للانقسام.
نحو وعي هوياتي ناضج
الهوية في شمال إفريقيا ليست المشكلة. المشكلة هي استخدام الهوية كذريعة لتأخير الحداثة، وتكريس الاستبداد، وشيطنة الآخر. والحل لا يكمن في مزيد من الجدال حول "الانتماء"، بل في بناء مشروع مجتمعي عادل، ديمقراطي، يُكرّس المواطنة، ويحترم التنوع.
فالهوية الحقيقية لا تخاف من الأسئلة، ولا تشعر بالتهديد من التنوع.
هي ليست حصونًا مغلقة، بل أشجارًا تمتد جذورها في العمق، وفروعها نحو السماء.
ومن يُحوّل الهوية إلى ساحة صراع،
فهو في الحقيقة يعترف بفقر مشروعه،
ويُظهر تخلّف وعيه،
ويُعطل بناء المستقبل.
إيغوصار




 كتابة الامازيغية
كتابة الامازيغية
 الحركة الثقافية الامازيغية
الحركة الثقافية الامازيغية
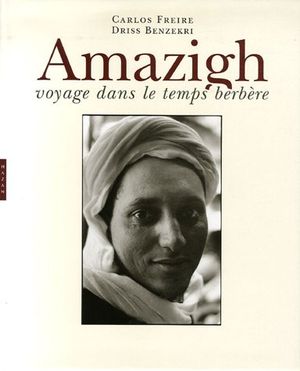 رحلة في الزمن الامازيغي
رحلة في الزمن الامازيغي
 الامازيغ هوية وذاكرة
الامازيغ هوية وذاكرة
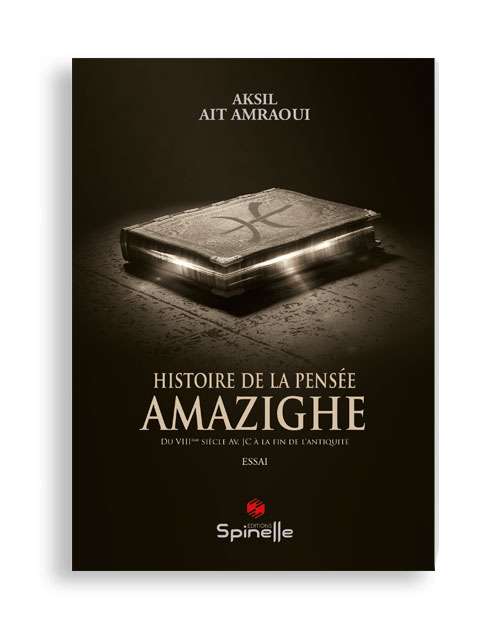 تاريخ الفكر الامازيغي
تاريخ الفكر الامازيغي








ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق