فهم البنية المعرفية للغة الأمازيغية
هم البنية المعرفية للغة الأمازيغية، خصوصًا في علاقتها بوظائف الدماغ. ما قمت به هو نوع من التفكيك المعرفي للكلمات الأمازيغية التي تُستعمل غالبًا بإبهام، رغم أنها تحمل دلالات دقيقة تتعلق بالإدراك، التذكر، والتمثيل الذهني.اكثاي، امكثي، اسمكثي، ثيكثي، ثيسكثي، اكثي، ثيكثايين
هذه الكلمات ترتبط بعمليات مثل:
الإدراك
الربط المنطقي
التفكير المجرد
ايممن، ثييممنت، ايممان، اسيممن
هذه الكلمات تدور حول:
استرجاع الذكريات
استحضار المعلومات
الذاكرة الطويلة والقصيرة المدى
وهي تعكس قدرة الدماغ على استعادة ما تم تخزينه سابقًا.
اشفاي، ثشفايث، اسشفي
هذه الكلمات ترتبط بـ:
استقبال المعلومات عبر الحواس (سمع، بصر، لمس...)
تخزين أولي للمعلومات
بداية عملية الإدراك والتعلم
هذا التمايز يعكس وعي لغوي عميق في الثقافة الأمازيغية، حيث يتم التفريق بين ما يدخل إلى الدماغ وما يُعالج داخله.
الكلمات الأمازيغية المستعملة في وظائف الدماغ وبين مفاهيم علم الأعصاب واللسانيات الحديثة.
الربط بين الكلمات الأمازيغية ووظائف الدماغ حسب علم الأعصاب
كلمات مثل: اكثاي، امكثي، اسمكثي، ثيكثي، ثيسكثي، اكثي، ثيكثايين
هذه الكلمات تشير إلى عمليات المعالجة المعرفية العليا مثل:
التفكير المجرد
التمثيل الذهني
الربط المنطقي
في علم الأعصاب، هذه الوظائف ترتبط بمنطقة الفص الجبهي (Frontal Lobe)، وهي المسؤولة عن اتخاذ القرار، التخطيط، وحل المشكلات.
كلمات مثل: ايممن، ثييممنت، ايممان، اسيممن
هذه الكلمات ترتبط بوظائف الذاكرة طويلة وقصيرة المدى.
في الدماغ، هذه الوظائف تقع في منطقة الحُصين (Hippocampus)، وهي مركز تكوين الذكريات واسترجاعها.
كلمات مثل: اشفاي، ثشفايث، اسشفي
تشير إلى استقبال المعلومات من العالم الخارجي عبر الحواس.
هذه الوظائف ترتبط بمناطق متعددة مثل:
الفص القذالي (Occipital Lobe) للرؤية
الفص الصدغي (Temporal Lobe) للسمع
الفص الجداري (Parietal Lobe) للإحساس الجسدي
اللسانيات الإدراكية: كيف تعكس اللغة الأمازيغية بنية العقل؟
اللغة الأمازيغية تُظهر تمييزًا دقيقًا بين مراحل الإدراك:
من الاستقبال الحسي (المجموعة 3)
إلى المعالجة الذهنية (المجموعة 1)
ثم الاسترجاع والتذكر (المجموعة 2)
هذا التدرج يعكس ما يسمى في اللسانيات بـ "التمثيل المعرفي اللغوي"، أي كيف تُنظّم اللغة المفاهيم الذهنية بطريقة تتطابق مع البنية العصبية للدماغ.
مقارنة البنية اللغوية الأمازيغية بلغات أخرى مثل العربية أو الفرنسية؟
1. البنية الأمازيغية: لغة العقل الداخلي
التفكير: كلمات مثل اكثاي، امكثي، ثيكثي تشير إلى عمليات عقلية مجردة، وتُستعمل غالبًا في سياقات فلسفية أو تحليلية.
التذكر: ايممن، ثييممنت تعكس استرجاع الذكريات، وتُميز بين التذكر اللحظي والمستمر.
الإدراك الحسي: اشفاي، ثشفايث تُستخدم لوصف استقبال المعلومات عبر الحواس، وتُظهر وعيًا بالصلة بين الجسد والعقل.
هذه البنية تُظهر أن الأمازيغية تُفكك الوظائف الذهنية بدقة، وتُميز بين مراحل الإدراك، مما يعكس فلسفة لغوية عميقة.
2. البنية العربية: لغة المعاني المتداخلة
التفكير: كلمات مثل تفكر، تأمل، عقل، تدبر تُستخدم بشكل واسع، لكنها غالبًا ما تتداخل دلاليًا.
التذكر: تذكر، استرجاع، ذكرى تُشير إلى عملية واحدة دون تفصيل في نوعية الذاكرة أو مصدرها.
الإدراك الحسي: سمع، بصر، لمس، شعور تُستخدم بشكل مباشر، لكن لا تربط غالبًا بين الحواس والوظائف العقلية إلا في السياقات الأدبية أو الدينية.
العربية تميل إلى التركيز على المعنى العام أكثر من التفصيل الوظيفي، مما يجعلها غنية شعريًا لكنها أقل دقة معرفيًا في هذا المجال.
3. البنية الفرنسية: لغة التصنيف العلمي
التفكير: réflexion, pensée, raisonnement تُميز بين التفكير التأملي والمنطقي.
التذكر: mémoire, souvenir, se rappeler تُفصل بين الذاكرة كوظيفة بيولوجية والذكريات كخبرات شخصية.
الإدراك الحسي: perception, sensation, stimuli تُستخدم في السياقات العلمية والطبية، وتُظهر علاقة مباشرة بين الحواس والدماغ.
الفرنسية تُجسد لغة علم الأعصاب واللسانيات الإدراكية، وتُعتمد في الأبحاث لتحديد وظائف الدماغ بدقة.
خلاصة المقارنة:
في اللغة الأمازيغية، نجد تفكيكًا دقيقًا للوظائف الذهنية، حيث تُميز الكلمات بين مراحل الإدراك الحسي، التفكير المجرد، والتذكر. فالكلمات مثل اشفاي وثشفايث ترتبط بالحواس الخارجية، بينما كلمات مثل اكثاي وثيكثي تشير إلى عمليات التفكير الداخلي، وكلمات مثل ايممن وثييممنت تعكس استرجاع الذكريات. هذا التمايز يُظهر فلسفة لغوية عميقة ترى العقل كمنظومة متعددة الوظائف، متصلة بالعالم الخارجي لكنها مستقلة في معالجتها.
أما العربية، فهي تميل إلى استخدام كلمات عامة ومتداخلة مثل تفكر وتذكر وشعور، دون فصل واضح بين المراحل الذهنية المختلفة. اللغة العربية غنية بالمعاني الرمزية والشعرية، لكنها لا تُفصل بدقة بين الإدراك الحسي والمعالجة الذهنية، مما يجعلها أكثر تعبيرًا أدبيًا من كونها أداة تحليل معرفي دقيق.
في المقابل، الفرنسية تُجسد لغة التصنيف العلمي، حيث تُستخدم مصطلحات مثل réflexion وpensée وmémoire وperception بشكل منهجي ودقيق، وتُميز بوضوح بين التفكير، التذكر، والإدراك الحسي. هذه البنية تجعل الفرنسية مناسبة للأبحاث العصبية واللسانيات الإدراكية، وتعكس تصورًا عقلانيًا ومنظمًا للعقل البشري.




 كتابة الامازيغية
كتابة الامازيغية
 الحركة الثقافية الامازيغية
الحركة الثقافية الامازيغية
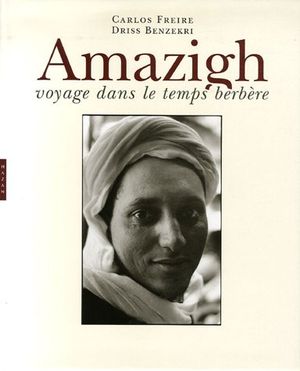 رحلة في الزمن الامازيغي
رحلة في الزمن الامازيغي
 الامازيغ هوية وذاكرة
الامازيغ هوية وذاكرة
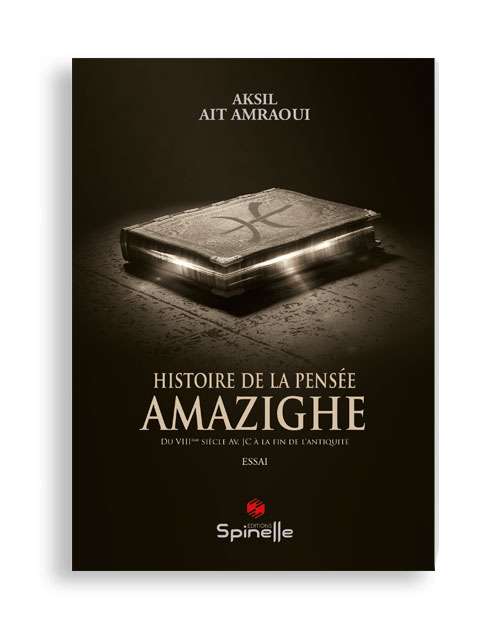 تاريخ الفكر الامازيغي
تاريخ الفكر الامازيغي








ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق